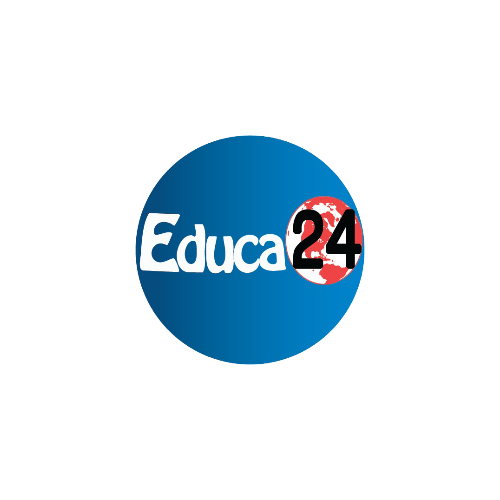حسن زهير
بداية أطرح السؤال التالي: ماذا يفعل المُدرسون داخل فصولهم الدراسية في علاقتهم بالمتعلمين؟ يقومون بما يُسمى في الأدبيات التربوية: أجرأة العملية التعليمية-التعلمية، أي أن الأستاذ يُعلّم والتلميذ يتعلم. يفعلون ذلك وفق بيداغوجيات محددة وديداكتيكات خاصة، يعرفها السادة الأساتذة من خلال مراكز التكوين ويمارسونها في فصولهم الدراسية داخل مؤسساتهم التعليمية، ما أمكن لهم ذلك وحسب ظروف عملهم؛ لكن ما هدف كل ذلك؟
الهدف، طبعا، كان ولا يزال تنمية قُدرات المُتعلمين لكي يتمكنوا من التعامل مع المشكلات المرتبطة بعمليات التحصيل الدراسي وبتقويمات الإنجاز المدرسي، من قبيل: حل المسائل الرياضية أو المسائل المتعلقة بالفيزياء أو بعلوم الحياة والارض، أو كذلك فهم فقرة من نص أدبي أو فلسفي أو تاريخي واستخراج آلياته اللغوية والحجاجية… إلخ.
الخلاصة، إذن، هي أن أدوار الأساتذة تتحدد في العمل على تطوير مجموعة من القدرات لدى المتعلمين، من أجل استخدامها في اكتساب وتخزين المعلومات والمعارف الجديدة، والتي تساعدهم على عمليات التحليل والتركيب والمقارنة، على اعتبار أن المعرفة، أساسا، هي نشاط استذكاري يقوم على ترميز المعلومة وتخزينها واسترجاعها. ولهذا السبب ركزت الأبحاث في السيكولوجيا المعرفية على مشكلة الذاكرة، حيث ميزت بين ذاكرة الاشتغال، أي قصيرة المدى، وذاكرة التخزين، أي بعيدة المدى، إذْ كان الهدف المطلوب، في نظامنا المدرسي، هو أنْ يمتلك المُتعلم القدرة على معالجة مشكلات مألوفة لديه، بل ويملك فكرة مسبقة عنها. ولكي يتمكن من ذلك كان يحتاج إلى ذكاء من نوع مُعين، وهو ما يُسمى في الأدبيات التربوية المعاصرة بالذكاء المعرفي-التحليلي. ولهذا اهتمت به المدرسة في مفهومها التقليدي، حيث تم التركيز حينها وطيلة القرن العشرين على ما يسُمي بـ”مُعامل الذكاء”، باعتباره المعيار الأسمى لقياس درجة النجاح المدرسي. وتكفي الإشارة هنا إلى الروائز السيكولوجية لقياس درجة التحكم في الكفايات اللغوية-المنطقية-الرياضية، وهي بالمناسبة مهارات النصف الأيسر من الدماغ؛ ذلك أنه بفضل الأبحاث الجديدة في العلوم العصبية اتضح أن الدماغ البشري مُنظم على شكل مناطق اشتغال مختلفة.. وهكذا فكل من جانبي الدماغ، الأيسر والأيمن، يختزن ذكاء يُميزه وله مهاراته الخاصة به.
تَبين، إذن، أن المدرسة التقليدية لا تعمل سوى على تنمية وتغذية المنطقة اليسرى من الدماغ لدى المتعلمين، أي مهارات الذكاء المعرفي-التحليلي، والذي بات واضحا أنه لا يعكس جميع قدرات المتعلم، إذ تم إهمال مهارات الجانب الأيمن من الدماغ. ولذلك، عمِلت المدرسة المعاصرة على توسيع مجال الذكاء ليشمل تنمية مهارات النصف الأيمن أيضا، لكي تجعل المتعلم قادرا على استخدام كل القدرات اللازمة للنجاح في الحياة بصفة عامة، وليس فقط النجاح المدرسي.
هذا الأمر يحتاج من مؤسساتنا التعليمية أنْ تعمل أيضا على تنمية نوع آخر من الذكاء، وهو ما يُعرف في نظريات سيكولوجيا المعرفة بالذكاء الإبداعي، أي جعل المُتعلم قادرا على التعامل مع المشكلات الجديدة وغير المألوفة لديه؛ وهو ما يتطلب الاشتغال على تنمية مهارات النصف الأيمن من الدماغ.
كيف يمكننا، إذن، أن نُنمي لدى متعلمينا هذه القدرة على التعامل مع الجديد؟ وكيف نساعدهم على تحقيق ذلك؟
الفصل الدراسي، كما يُمارَس اليوم، لا يعمل على تنمية هذا النوع من الذكاء، ربما بسبب ضغط البرامج الدراسية أو بسبب أشياء أخرى. ولذلك، يُمكن استثمار مجال أنشطة الحياة المدرسية الموازية وتوظيفها كأساس للعمل على تنمية مهارات الذكاء الإبداعي لدى المتعلمين.
ولهذا، أود في هذا المقالة أن أتوقف سريعا عند أهمية هذا النوع من الذكاء من خلال الإشارة إلى النقط التالية:
أولا: إن تنمية الذكاء المعرفي-التحليلي في مجال مُعين سيُقوي، دون شك، الإمكانات الإبداعية لدى المتعلم، وكذلك فإن تشجيع الإبداع ستكون له انعكاسات إيجابية على الذكاء المعرفي-التحليلي. ويكفي أن نذكر، في هذا السياق، أن تطوير المعرفة بالتقنيات السردية مثلا لدى المتعلمين في المجال الأدبي سيكون مفيدا جدا لهم في الإبداع القصصي أو الروائي؛ ذلك أن الإبداع والذكاء وجهان لظاهرة واحدة حتى قيل إن “إبداعا دون ذكاء قد يتحول إلى تفكير فوضوي، وذكاء دون إبداع سيتحول إلى مجرد معرفة خاملة”.
ثانيا: إذا كان القرن العشرون قد تميز، على مستوى التقويمات التربوية، ببلورة “مُعامل الذكاء” الذي حدد النجاح المدرسي من خلال تصنيف المتعلمين، حسب قدراتهم في التفكير والتحليل والبرهنة وسرعة معالجة المعلومة والذاكرة، فإن القرن الحادي والعشرين اعتبر الكفاية الإبداعية أحد أهم الكفايات المفتاحية المطلوبة في عصرنا. ويكفي أن نذكر في هذا الصدد ثلاثة مؤشرات ذات صلة بالموضوع:
ـ المؤشر الأول يتعلق بـ”البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ” المعروف اختصارا بـ (PISA)، والذي اقترح ضرورة تقويم الكفايات الإبداعية لدى المتعلمين في دراساته المُقبِلة.
ـ المؤشر الثاني له علاقة بالمنظمة الأوروبية المهتمة بعالم التربية والتعليم في الاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرت أن الكفايات الثمانية المعروفة في النظام المدرسي الأوروبي أصبحت تتطلب إدماج البعد الإبداعي، وتنميته في كل كفاية من الكفايات المفتاحية الثماني المُعتمدة في الأنظمة التربوية المعاصرة.
ـ المؤشر الثالث يرتبط بتوصيات تيار بيداغوجي معاصر يجتمع تحت عنوان “مهارات القرن الحادي والعشرين”، حيث اعتبر أنه على المدرسة المعاصرة أن تضيف كفاية خامسة إلى الكفايات الأربع السابقة، التي كانت تعمل على تنميتها في الأنظمة التربوية، أي القدرة على التفكير النقدي، القدرة على التواصل، القدرة على حل المشكلات، والقدرة على التعاون. وهذه الكفاية الخامسة هي القدرة على التفكير الإبداعي المُبتكر والخلاق، أي تعليم التلاميذ التفكير بشكل مختلف والعمل على مشاريع تعاونية بشكل إبداعي، بالإضافة إلى تجريب أفكار جديدة في أشكال منتوجات إبداعية ملموسة. إلخ.
كل هذا النقاش حول الكفايات الإبداعية يفرض علينا ضرورة طرح السؤال حول كيفية جعل مؤسساتنا التعليمية مجالا لتطوير الذكاء الإبداعي لدى مُتعلمينا، ما دام الفصل الدراسي بسبب ضغط البرامج يقتصر، فقط، على تنمية ذكائهم المعرفي-التحليلي. وللقيام بذلك يُستحسن أن تُدرج أنشطة الحياة المدرسية الموازية ضمن استراتيجية تعمل على تطوير هذه الكفايات الإبداعية لدى المتعلمين، وتكون قابلة للقياس والتأطير والمراجعة والتطوير. وفي هذا الصدد، يمكن أن أكتفي بالإشارة إلى نقطتين أساسيتين:
ـ الأولى تتعلق بالعمل على تنمية المهارات التي تجعل المتعلم قادرا على استعمال وتنظيم معلوماته ومعارفه السابقة في التعامل مع مشكلات جديدة، وذلك بشكل إبداعي وخلاق، مقارنة مع ما يفعله عادة في الفصول الدراسية حيث يكون، باستمرار، أمام مشكلات مألوفة ويملك فكرة مسبقة عنها. مثل هذا الأمر هو الذي سيُمكنه من اكتساب مهارات جديدة، أي تلك المرتبطة بالنصف الأيمن من الدماغ والتي تُحفز الحس الإبداعي لدى الأفراد.
ـ الثانية تتعلق بالقدرة على تحويل هذه المهارات الجديدة، والتي اكتسبها المتعلم في مواقف لم يسبق مواجهتها من قبل، إلى مهارات آلية، أي لم تعد تحتاج إلى الاستغراق كثيرا في استخدام الذاكرة، وهذا الأمر مفيد جدا لمُتعلمينا لفهم المواقف وإبداع الحلول في الحياة اليومية، بطريقة شبه آلية، إذ عبْر امتلاك قُدرة التحويل الآلية هاته يكتسب المتعلم بالتدريج ذكاء إبداعيا وعمليا: إنه ذكاء الحياة اليومية الذي يجعله، باستمرار، قادرا على تحديد جوانب القوة لديه لكي يعمل على تدعيمها، واكتشاف جوانب الضعف لكي يجتهد في تصحيحها.