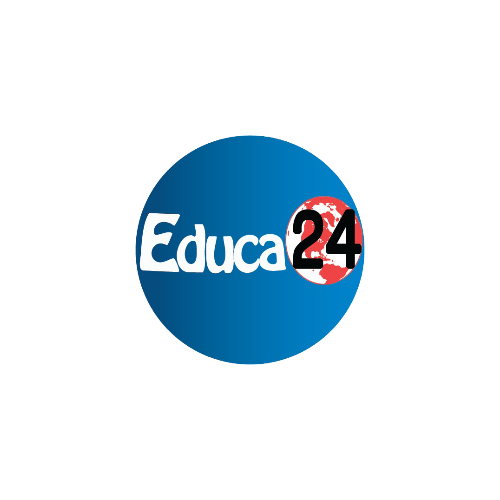تعد النزعة البراغماتية من سمات التحضر لإنسان الألفية الثالثة، إذ هناك سطوة متنامية للثقافة البراغماتية – أمريكية الأصل، لا تعترف بالحدود ولا بالهويات المحلية.
يتأسس المذهب البراغماتي على الاستجابة للحاجيات الأساسية التي تعود بالنفع على المجتمع، من خلال توظيف الخبرة لحل المشكلات الواقعية. وباختصار، ارتبط الفكر البراغماتي بمتطلبات الحياة اليومية للأفراد والمجتمع، وتلك هي البراغماتية في أفضل حالاتها.
ولا شك في أن أمريكا كانت أفضل حالاتها، على حد تعبير الفيلسوف الأمريكي المعاصر كورنيل ويست؛ وبالتالي، فالمذهب البراغماتي الغربي جاء كبديل عملي للنمط الأرستقراطي، وبشكل يوازي التوجه الرأسمالي في شموليته، وهذا هو بالضبط مضمون التربية البراغماتية في فلسفة جون ديوي، حيث تُعَلبُ حاجات ورغبات وتطلعات وطموحات الأطفال داخل صندوق فاوستي سميك وتغلف جيدا بغلاف الاهتمام النفعي وتصبح الأخلاقيات والجماليات الإنسانية بمثابة حكاية تراثية عابرة، لا مكان لها ضمن متطلبات ومطبات الحياة اليومية، هذا هو إذن الاختزال البراغماتي للتربية.
إذا تأملنا واقعنا نحن المغاربة وباقي شعوب بلدان الجنوب تتجلى مفارقة واضحة جدا، وهي أن النظريات الفلسفية والمقاربات التربوية بمثابة بذور مختارة مستوردة من الخارج تزرع بتربة غير ملائمة. وعلى الرغم من تحول هذه البذور إلى نباتات خضراء فإنها لا تزهر، وتظل عقيمة تماما كشجرة زيتون، حينما تُغرس ببلاد الضباب. ولذلك، فالمذهب البراغماتي الغربي لا يمكنه الإحاطة بالبراغماتية المغربية الناشئة التي تتميز بخصوصيتها المستمدة من تربتنا وهويتنا، السمة نفسها تطبع مقاربة الكفايات المغربية التي لها خصوصيتها وسياقها؛ وهذا بالضبط روح التفكير البراغماتي، الذي ينظر إلى الهدف والمنفعة الحقيقية المتوقعة متمسكا بالأرض لا محلقا في السماء، لكن للبراغماتية المغربية رأي آخر في انتقاء الأهداف واختيار أسلوب وأدوات تحقيقها.
في هذا السياق يجب أن نميز بين براغماتية إيجابية وأخرى سلبية؛ بالنسبة للإيجابية فتتمثل في اعتماد الدولة لرؤية واقعية مستمدة من السياق الدولي العام، رؤية تؤسس لتعليم تقني من خلال الاهتمام بالمسارات المهنية إلى جانب تعليم علمي، مقابل إهمال التعليم الأدبي – الاجتماعي الفلسفي، وبلا شك للدولة مبرراتها التي لا تخرج عن التوجه الدولي الذي يميز الألفية الثالثة، فطبعا نحن نعيش في زمن نهاية الإنسان وبداية مرحلة جديدة “الإنسان شبه الآلي”، الذي لا يحتاج حتما إلى تفكير نقدي ولا إلى ذوق جمالي ولا إلى إدراك زمني، كل ما يحتاجه امتلاك مهارة ما، أي القدرة على الإنتاج إلى جانب القدرة على الاستهلاك. ما يهمنا هنا هو أنه يمكن اعتبار هذه البراغماتية إيجابية عموما، مثلها مثل براغماتية الأسر التي تتبنى الرؤية نفسها وللأسر مبرراتها أيضا التي تتمثل أساسا في متطلبات سوق الشغل، الذي لا يحتاج إلى حاصلين على شواهد عليا في الآداب والعلوم الإنسانية. لذلك، فالأسر تبحث عن أقصر وأسهل الطرق لولوج أبنائها “نموذج الرفاه الاجتماعي”.. وحينما يتعذر مطلب “التقنيات والعلوم” يبقى خيار الآداب والعلوم الإنسانية حلا مقبولا لاقتحام نموذج الرفاه الأدنى، وذلك أقل ما يُطلب. في المقابل، هناك براغماتية سلبية مسكوت عنها، ربما لا توجد بأمريكا، مهد المذهب البراغماتي؛ لكنها توجد ببلادنا بشكل لا يطاق. وتتجلى، باختصار، في الترجمة الشعبية لما يسمى “مدرسة النجاح”، حيث تصبح المقاربة الكمية أنجع الوسائل لإنجاح مدرسة النجاح. والنجاح هنا هو تحقيق نسب مرتفعة تتراوح ما بين 80 في المائة و90 في المائة كناجحين عن كل مستوى، وخاصة مستويات الباكالوريا التي تشكل واجهة التعليم المغربي. تضمن هذه النسب تخفيف الاكتظاظ بشكل ملموس، وعكسها يعني بالضرورة مشكلة حقيقية في الدخول المدرسي الموالي، فضلا عن تداعيات الأرقام والنسب على مؤشر التنمية البشرية واستمرارية تشجيع التعليم من طرف الهيئات الدولية.
يتم تحقيق الهدف الأسمى “النجاح” من خلال جملة من الترتيبات والإجراءات المباشرة وغير المباشرة؛ من بينها نمط التقويم ولجان الرقابة والفحص المترقبة للنتائج، والتي تستهدف خصوصا المؤسسات التي تحقق نسب نجاح منخفضة، كتلك التي تقل عن 40 في المائة، حيث تؤشر هذه النسبة على تقصير محتمل من لدن الأطر التربوية، في المقابل تمنح شهادات تقديرية لأصحاب النسبة المرتفعة. ويعلم الجميع كيف يتم تحقيق بعض النسب الخيالية المغشوشة، وهنا يمكننا إثارة الحالة المتداولة إعلاميا لمؤسسة حققت 100 في المائة كنسبة نجاح – دورة يونيو 2024، أليس من الضروري في هذه النازلة التربوية العمل بالقاعدة المالية “من أين لك هذا”؟ ربما تكون هذه المؤسسة نموذجا للتغيير المأمول، وبذلك يتم تقاسم تجربتها الرائدة وربما الفحص يأتي بالعكس.
ومن الترتيبات أيضا ما هو عفوي وشبه عرفي، يتمثل في تداول التوصيات الأفقية والعمودية أحيانا بأهمية الحرص على تشجيع مقاربة النجاح. هكذا، تدخل الأطر التربوية والإدارية معترك “المقاربة الكمية” وتصبح الفاعل الأول في إنجاح “سياسة النجاح”، التي تصبح فضيحة تربوية حينما تتم مقارنة معدلات المراقبة المستمرة ومعدلات الامتحانات الإشهادية، على الرغم من أن هذه الفئة تنكر بشكل دائم التماهي مع هذا التوجه الخفي والمسكوت عنه، وتعبر على رفضه بشكل يومي، ولهذا التناقض مبررات معقدة “مهنية واجتماعية وإنسانية…” لكن يظل أخطرها وأغربها هو سيادة المقارنة الكمية والسعي نحو المزايدة في النفخ. هكذا تنمو وتتجذر النزعة البراغماتية المقيتة بقطاع التعليم، تماما كقطاع الصحة. وبذلك يُنظر إلى التعليم والتربية بمنظار نيوليبرالي محض، في اختزال سافر للغايات الكبرى للنظام التعليمي، تحت عنوان “رأسملة التعليم وتكميم حصيلته”، وهنا الكل يشارك من موقعه، من أصحاب القرار إلى المتعلمين وأولياء الأمور، مرورا بالإدارة التربوية وهيئة التدريس، والمشاركة طبعا تتخذ أشكالا وألوانا متعددة.
إذن، تشمل البراغماتية السلبية الأسر أيضا، إذ هناك إجماع على أهمية النجاح في حد ذاته؛ فلا يهم أن يتقن الابن المتعلم بالثالثة إعدادي القراءة والكتابة باللغة العربية على الأقل، بقدر ما يهم أن ينجح ويقفز إلى المستوى الموالي أي الثانوي التأهيلي، وفي واقع الامتحانات الإشهادية للسلكين الابتدائي والاعدادي عبرة لمن يعتبر، فلا شيء يعلو فوق السعي وراء النسب المنفوخة، لتحقيق “العلامة الكاملة 100 في المائة”؛ وهذا ما يحدث سنويا بالكثير من المؤسسات الابتدائية والإعدادية، في تناقض صارخ مع ما كشفه وزير التربية الوطنية (2021)، الذي أكد أن 70 في المائة من التلاميذ يواجهون صعوبات في القراءة والكتابة والرياضيات. هكذا يصبح التطبيع مع تيار الغش ودعمه بشكل خفي حلا لا مفر منه، باعتباره طوق نجاح ونجاة، وهذا هو بالضبط أصل الأزمة. لذلك، تتطلب هذه المرحلة الحساسة الوضوح وعدم الانسياق التام وراء شرعنة الغش والضرب في تكافؤ الفرص والتغييب المطلق للضمير المهني، وعلى العكس من ذلك يجب العمل بمقولة “ما لا يُدرك كله لا يُترك جُله” والمقصود هنا الضمير المهني بالضبط؛ فالتنازل عن الجزء لا يعني بالضرورة التفريط في الكل.
حينما يصل “ضحايا وأبطال ظاهرة الغش” إلى مستوى الثانية باكالوريا، يتم توفير جميع شروط النجاح من ساعات إضافية ومن كتب إضافية أيضا “كل ما ينفع تحقيق الهدف”؛ بل حتى هواتف إضافية يوم الامتحان، إن اقتضى الأمر، يتم تسخيرها من لدن الأسرة لضمان نجاح عملية النجاح المغشوش. هذا هو واقعنا المر والمسكوت عنه؛ فغالبية الأسر تراهن على النجاح مثلها مثل أغلب أصحاب المكاتب المكيفة والكثير من أصحاب الأقلام الملونة. وطبعا التلميذ هو سيد المذهب البراغماتي؛ فهو يتعلم ويبدع أيضا، إذ تجده يتعامل مع المراقبة المستمرة بشكل آني وآلي في غياب تحفيز ومتابعة حقيقية من لدن الأسر وصرامة فعلية من لدن بعض أهل التربية. كما أنه لا يتوانى ولا يخجل من طلب “صدقة النقط”، إلى درجة أصبح هذا السلوك “عرفا” تلاميذيا شائعا. الأكثر من ذلك هو طريقة استعداد فئة واسعة من التلاميذ للامتحانات، حيث يصبح الاستعداد مرادفا لهدر الزمن، بحيث لا يخرج عن التخطيط للغش وسرقة النجاح بأي شكل من الأشكال. وكما يقول المثل الشعبي “لي سرق بيضة يسرق عجل”، ويعني ذلك أن من سرق النجاح قادر على سرقة الوطن، والسرقة هنا تعني على الأقل القدرة على الإضرار بالمصلحة العامة بضمير بارد، وذلك أضعف الأفعال. وطبعا، هذا القول لا يعني بالضرورة التعميم؛ فدائما تظل هناك فئة واسعة من التلاميذ تعرف ماذا تريد وتتحرك نحو الهدف بجدية واجتهاد وطموح؛ لكنها فئة قليلة جدا تُضمر تذمرا دائما جراء هذا الواقع المأزوم الذي يؤثر على تكافؤ الفرص وجودة بناء التعلمات ونمط التقويم، بل يؤثر على وتيرة وجودة التنمية برمتها، حينما يتبارى على المناصب خريجو تيار الغش… هكذا يستمر التيار في تطعيم دائرة الغش، بشكل يضمن مناعتها واستمراريتها بمؤسساتنا العمومية وحتى الخصوصية، مستفيدا من القيم الشعبوية المحفزة على الغش المهني والاجتماعي والاقتصادي…