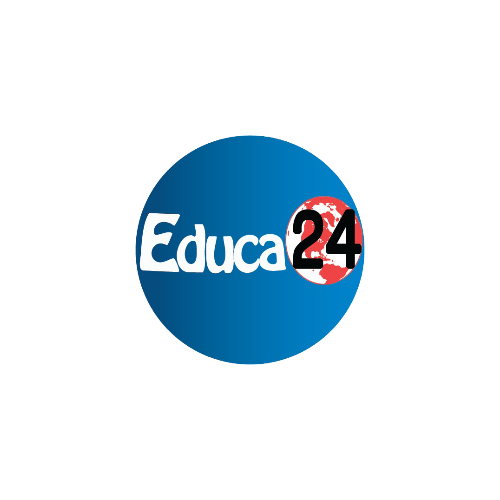تُعَد السُّخرية من الفنون الهلامية الّتي لا تقبل التّكميم، فأي محاولة لتعريفها ستنتهي بنا إلى الخنق الفنّي لها، ولربما يرجع ذلك إلى مصطلح السّخرية في حدّ ذاته، فهو من بين ما يحيل عليه، ظواهر الغضب، والانتقام، والخضوع، والصد، والصراع. وتختلف السّخرية باختلاف المواضيع، ولكلّ موضوع حججه واستبياناته وتقنياته الخاصة، وهذا ما جعل السّخرية سخريات تستعصي على الضّبط الأكاديمي. ولسنا هنا بصدد التعريف أو التقعيد أو جرد آراء من تطرقوا للموضوع. ما يهمنا هنا هو ذلك البطل الذي يبدع الفعل الساخر، سواء كان رسما أو قولا أو سلوكا…، دوافِعُه، أهدافُه، وأثَرُ مَنتوجِه السَّاخِر في نفس المتلقي، وفي المجتمع.
يحكي أحد أبطال السخرية المجهولين النُّكتَة التالية:
“وَاحْد مْشَى يْجِيبْ وَلْدو من الحَضانَة.. خَرْجاتْ عَنْدو المربية وقَالت لِيهْ: شْكُونْ هُوَ وَلْدَك؟ قَال لِيها: أَرَايِ شِي وَاحْدْ فِيهُوم.. اللِّي كَان، ياكْ غْدَّا فْ الصْبَاح غَادِي نْرَدُّو لِيكْ”.
يعرف معجم المعاني النكتة بأنها العلامة الخفية، الفكرةُ اللطيفة المؤثِّرَة في النفس، شِبْهُ وسَخٍ في المِرآة أَو السَّيف… ونرى أن هذه التعريفات تنطبق على النكتة أعلاه. كلما قلَّبناها على جانب تفيد معنى مختلفا، وكلما تلَقَّيناها من زاوية مختلفة تخلُق أثَرا مغايرا.
وكما يتضح من أول صِدامٍ مع هذه النُّكتَة يتبين أن موضوعها هو “حراسة الأطفال” / الحضانة، غير أنه بإعادة قراءة النكتة والتمعن فيها تنفتح في كل مرة على فهم جديد، وموضوع جديد، وما تفتأ تتوغل فينا ومن خلالنا في المجتمع وتنكأ الجراح الهامدة فينا وفي هذا المجتمع، والتي اعتدنا أُلفَتَها والتعايُش معها، على الرغم من الألم الذي تخلفه فينا في كل لحظة نواجهها.
وإذا كانت النكتة نوعا من أنواع الأدب الشعبي وتحكى قصة صغيرة أو موقفًا أو تسلسلًا من الكلمات الذي يُقال/يُكتب/يُشاهد بغرض التأثير على المتلقي وجعله يضحك، فإن هذه النكتة تُبكِينا من فرط الضحك وفي الوقت نفسه تُضحِكنا من فرط الألم، لذلك لم يخطئ القول المكثَّف الدارج: “كثرة الهم كتضحك”.
وهَمُّ الأطفال في هذا العصر أصبح غير متحمل، لا من طرف الأسرة ولا من طرف المجتمع ولا من طرف الدولة، “واحد مشى يجيب ولدو من الحضانة..”، وأضحت تربيتهم وتلبية احتياجاتهم الفطرية والثقافية أثقل حجَرٍ يحمله الآباء والأولياء والأمهات على أكتافهم، وقد زادت هجمة العولمة الرقمية والتكنولوجيا من ثقل هذه المسؤولية، هذه الهجمة التي لم يستعد لمواجهتها أحد، وأصبح الولد والوالد سيان في مرماها دون قدرة ولا معرفة على التصدي، ولا حتى على إدارتها بقدر من الحكمة والتعقل وقليل من الوعي للتخفيف من آثارها عليهما.
هجمت الرأسمالية على الأسرة، في مرحلة أولى من خلال التلفزيون، الذي أصبح الناطق الوحيد داخل البيت، على الجميع أن يلوذ بالصمت عندما يتحدث، تحت طائلة العقاب، وفي كثير من الأحيان المشاداة الكلامية. لتهجم في مرحلة تالية بأكذوبة “الحقوق”؛ حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المعاق… لتنشر هذه الأكذوبة مثل السرطان وتتفرع في حقوق فئات كثيرة، كل ذلك على حساب حقوق الأسرة باعتبارها نواه المجتمع، واشتد الصراع بين مكونات الأسرة وأصبح كل فرد يطالب ويتمسك بحقوقه على حساب حقوق الآخرين، حقوق الجماعة/الأسرة… وأصبحت هذه الأخيرة مجرد قوقعة فارغة.
في هذه الحمى أُخرِجت المرأة من بيتها للعمل، وأُخرج معها أطفالها إلى الحضانة وانفصمت لُحْمة الأسرة، وبدأت تتغير الأدوار والمهام، وما عادت الأم حاضنةً، بل أصبحت “الحضانة” هي الحُضن الذي يقضي فيه الطفل طفولته منذ انقضاء الفترة القانونية للأمومة (تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا،../ المادة 152 من مدونة الشغل). وما عادت الأُّمُّ أُمًّا مُربِّية (يحق للأم الأجيرة ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة. وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما/ المادة 156 من مدونة الشغل)، ولذلك “خرجات عندو المربية وقالت ليه: شكون هو ولدك؟”، ولا عادت مَدرَسَةً إِذا أَعدَدتَها، أَعدَدتَ شَعبا طَيِّبَ الأَعراقِ…” وزادت الهواتف الذكية من تعميق الهوة.
وفي خضم هذا الوحل، بدأت تضمحل أواصر القرابة والحميمية، ويتلاشى جوهر الأبوة والأمومة والبنوة، “قال ليها (الأب): أراي شي واحد فيهوم.. اللي كان”، عبارة بسيطة تبدو عفوية، لكنها محملة باللامبالاة واللااهتمام، ما عاد الأبُ أَبا ولا الطفل ابنا، لا يهم من يكون هذا ولا من يكون ذاك. قَاعُ انهيار الأسرة، وقَرارُ اضمحلال الإحساس بالأبوة، بالمسؤولية، بالإنسانية، وكأن هذا الطفل حذاء أو مقلاة، شيء يُعار ويُستَعاد، ولا يرقى حتى إلى مرتبة قط أو سلحفاة.
زاد من حدة هذا القهر المُهين الذي تعيشه الأسرة إقرار التوقيت الإداري المستمر، وأصبح معه أفراد الأسرة أشبه بزملاء يجمعهم الليل فقط تحت سقف واحد، وأضحت حياتهم أشبه بحياة الطلاب في السكن الجامعي، أو العمال المهاجرين في المدن الصناعية، “ياك غدا ف الصباح غادي نردو ليك”، بعقلية هؤلاء فكر هذا الأب، سآخذ الطفل/الابن ليبيت في المنزل فقط، الحد الأدنى من المسؤولية، وربما لو كانت “الحضانة” توفر خدمة المبيت لَتركَه هناك حتى نهاية الأسبوع ليأخذه من أجل الاستحمام، ونادرا من أجل الاستجمام، ولو توفرت هذه الخدمة أيضا لربما بقي الطفل هناك حتى يبلغ أشده، وربما حتى يستقل بحياته، وتبدأ دورة حياة جديدة…
تتمتع النكتة بجوامع الكلم، “فنكتة واحدة يفهمها السامع خير من مئة درس في المنطق” بحسب رأي عباس محمود العقاد. وهذه النكتة تغني عن المئات من الوصايا والدروس والمحاضرات…، نكتة كثَّفَت أزمة المجتمع، أُمَّ الأزمات، في أعوص المشكلات اليومية للأسرة، في موقف يتكرر خمسة أيام في الأسبوع، في عبارة مُركَّزة، تُضحِك من حيث تُبكي وتُبكي من حيث تُضحك، لعلها تشكل السبيل الوحيد لعودة إنسانية الإنسان “فلا مُضحِك إلا ما هو إنساني، والنكتة هي محاولة قهر القهر.. وهتاف الصامتين” وفق “Henri Bergson”. فهل من سامع لهذا الهتاف، لهذه الصرخة المخنوقة في حنجرة أب حاول أن يقهر القهر الذي يعانيه بهذه العبارة “أراي شي واحد فيهوم.. اللي كان، ياك غدا فالصباح غادي نردو ليك”.
قسَّم الفيلسوف سقراط السخرية إلى صنفين، يتعلّق الصنف الأول بإدارة العملية التّحاوريّة الهادفة، في حين يتماهى الصنف الثّاني مع تداولية الحياة باعتبار السّخرية لازمة للحياة لا يمكن الاستغناء عنها، وكأني به توصل إلى هذه الخلاصة بعد الاطلاع على هذه النكتة. فهي فعلا تجمع بين إدارة العملية التحاورية الهادفة وبين تداولية الحياة. وهذا التصور الفلسفي العميق الذي رهن السّخرية بنظام الحياة، وتفعيل إدارة العملية التّخاطبية جعل الفيلسوف الألماني “Soren Kierkegaard” يَسِم سقراط بالأستاذ المثالي للسّخرية دون منازع. ونحن من جانبنا، ومن واجبنا ربما، أن نَسِم مُبدِع هذه النكتة بالأستاذ المثالي للسّخرية دون منازع.
وكُلُّ أَزمَةٍ وأَنتُم تَسْخَرُون..