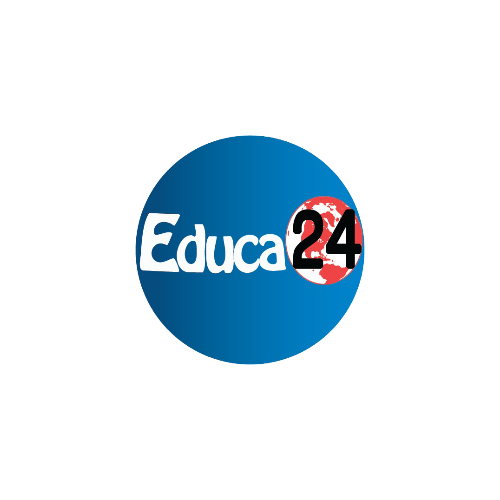قبل سنوات، وفي حوار لي مع إحدى الجرائد الوطنية، تحدثت مطولا عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين. عن أدواره المفترضة، وعن الانتظارات العريضة التي علقها عليه الرأي العام، والفاعلين التربويين تحديدا، وعن تلك الهوة المؤلمة بين المنتظر والمتحقق. يومها قلت أمرا ما زلت أؤمن به: إن هذه المؤسسة، التي كان يفترض أن تكون بوصلة إصلاح، تحولت في لحظات كثيرة إلى فضاء شكلي يعيد إنتاج نفس الخطاب النقدي ونفس النوايا الطيبة، ونفس الاقتراحات والتوصيات الأنيقة التي تعمق فينا أفق الانتظار...
واليوم، مع خبر إعفاء السيد الحبيب المالكي وتعيين الدكتورة رحمة بورقية، أجدني لا أصفق ولا أتحسر. بل أعود إلى السؤال نفسه، وقد تلونت الأعطاب وتراكمت: هل يكفي تغيير الوجوه لإيقاف نزيف المنظومة؟ هل يكفي أن نبدل القيادة كي تنقلب الوظيفة؟
إن رحمة بورقية، بكل ما تمثله من صرامة أكاديمية وتجربة مؤسساتية، ليست مجرد وجه جديد. بل هي وعد بإعادة ترتيب العلاقة بين المجلس والمجتمع، بين التفكير التربوي والواقع التعليمي البئيس. لكن هذا الوعد سيظل معلقا ما لم تتم اعادة النظر في طريقة اشتغال المؤسسة نفسها، وفي موقعها من القرار التربوي، وفي استقلاليتها الرمزية.
لقد بدا المجلس، في مراحل كثيرة، كما لو كان جمعية مدنية محصورة الأفق، تشتغل بوسائل تقليدية على مشاكل بنيوية، وتنتج وثائق ممتازة لكنها لا تلامس مفاصل التغيير الحقيقي. والمشكل، في نظري، لم يكن في الأشخاص فقط، بل في طبيعة التعاقد الضمني بين الدولة وهذه الهيئة: هل نريدها للتفكير الحقيقي في اعطاب المنظموةالتربوية ؟ أم مجرد غطاء يخفي انتماءه إلى المنظومةالمعطوبة؟ وإلا ما معنى هذا الإعفاء إن لم يعبر عن ديمومة الخلل وجدليته الخفية بين الأزمتين: أزمة المجلس وأزمة المنظومة؟
لكن، رغم كل ذلك، يبقى الأمل ممكنًا. فالتعيين الجديد قد يكون أكثر من مجرد تناوب على الأدوار؛ قد يكون بداية مرحلة تتأسس على الإصغاء الحقيقي، وعلى الجرأة في التشخيص، وعلى الاستعداد لفتح الملفات المؤجلة. وإذا اجتمع في شخص الرئيسة الجديدة الوعي العلمي والحس المؤسساتي والجرأة القيادية، فبإمكان المجلس أن يستعيد دوره الطبيعي كقوة اقتراح، لا كجهاز تقني يشتغل في الظل.
الأمل ينتزع بإرادة صلبة ورؤية واضحة. فلنراهن على يقظة الضمير التربوي، وعلى من اختار أن يحمل هذا العبء في لحظة يتقاطع فيها الإصلاح بالحاجة، والفعل بالأمل.